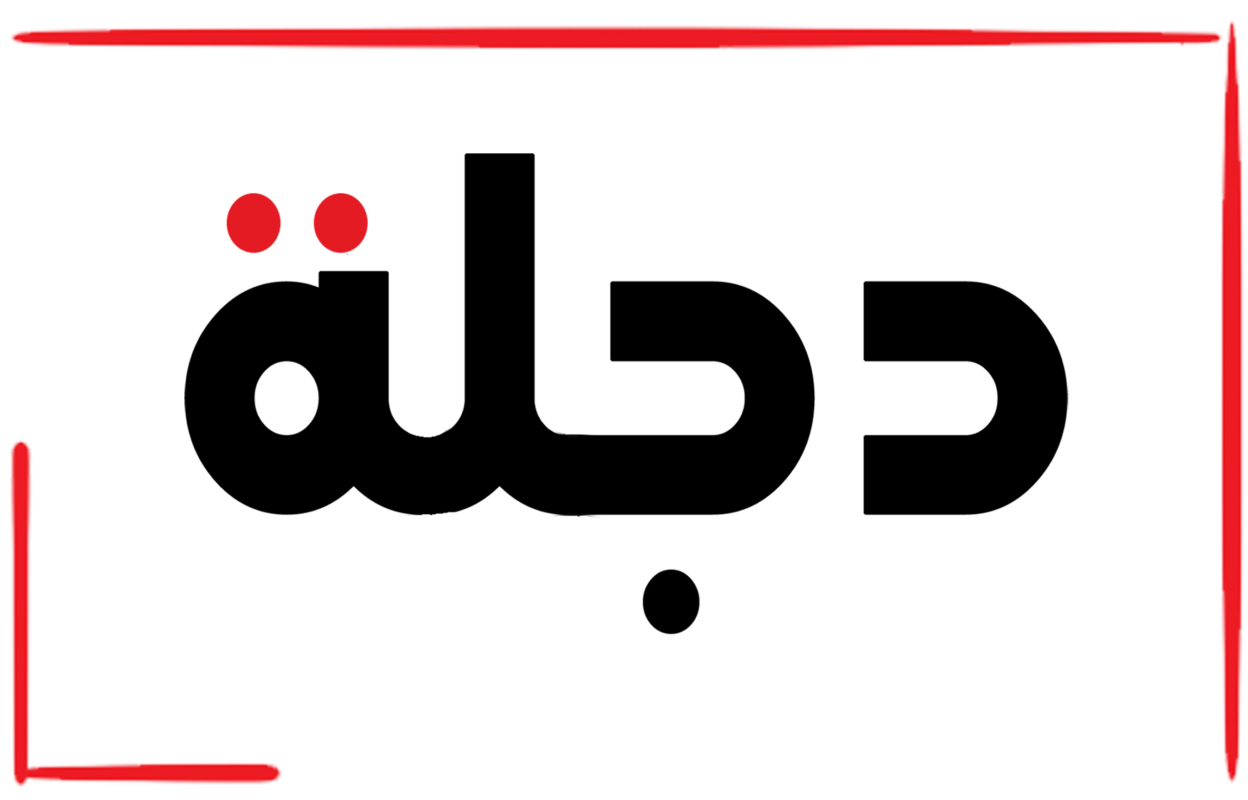حماية القتلة ليست مجرد خطيئة سياسية لزعماء الطوائف، بل وزر تاريخي سيُثقل كاهل الطوائف والنخب التي تصرّ على الاصطفاف خلفهم… وزر دماء مئات آلاف السوريين الذين قُتلوا على مدى 14 عاماً على يد جنود بشار الأسد وحلفائه من الروس والإيرانيين، لن يُمحى بالعفو ولا بالمساومات.
- من يقف خلف الشرع شريك في المغنم والمغرم.
- من يدعم قسد سيتحمّل ثأر العشائر العربية لعشرات السنين.
- من يصفّق لـلهجري سيتحمل صمة الخيانة، ويحمل وزر دماء سفكها ضباط الأسد الذين يحميهم.
- ومن قاتل إلى جانب بشار الأسد سيتوارث أوزار المجازر، حتى لو منحته الحكومة عفوًا سياسيًا.
السؤال الذي يجب طرحه اليوم، لماذا ارتفعت أصوات الطوائف السورية من غير العرب السنية – الكردية والعلوية والدرزية – عندما تعرضت لهجمات من قوات الحكومة الجديدة، وكانت أعلى بكثير من صوت العرب السنة الذين قُتلوا على مدى أربعة عشر عامًا؟
السؤال يفتح بابًا على جرح لم يلتئم بعد، فالضحايا الذين سقطوا في حمص وحلب ودير الزور وريف دمشق، كانوا يرون أن جزءًا من دمائهم أُريق برضا ضمني، أو على الأقل بصمت، من جماعاتٍ كان النظام قد أدرجها في سردية “الأقليات المهددة” لتبرير مشاركتها أو قبولها بأجهزته القمعية، فشهدث سوريا عمليات محاسبة داخل الطائفة الكبرى لم تواجه اعتراضات أو تمترس خلف سلاح العشيرة والطائفة.
منذ الأيام الأولى للثورة، وظّف نظام بشار الأسد البنية الطائفية السورية باعتبارها رصيدًا استراتيجيا يدعم تشكيل ميليشيات محلية على أسس مذهبية أو قومية، وأعطى امتيازات للزعامات التقليدية والأحزاب ذات أيديلوجيا معينة، مقابل التزامها بضبط مجتمعاتها كالكرد في الجزيرة والشمال أو الدفع بأبنائها للقتال تحت شعار “الدفاع عن الوجود” بالساحل، فالعلويون حملوا عبء الدفاع عن النظام في مؤسساته الأمنية والعسكرية، فيما غضّ النظام الطرف عن عسكرة بعض التشكيلات الدرزية، واستخدم الدروز كاحتياط سياسي وعسكري، عبر اتفاقات خاصة مع شيوخهم وزعمائهم.
في جميع هذه الحالات، لم يكن الهدف حماية المجتمع المحلي بقدر ما كان ضمان استمرار منظومة السلطة، ومن هنا يمكن فهم كيف ارتبطت أسماء ضباط وميليشيات من هذه المكونات بمجازر كبرى مسرحها الأراضي السورية من دير الزور إلى ريف حماة، ومن القصير إلى الغوطة.
بالتوازي، نشأ خطاب يقدّم هذه الطوائف بالشمال والجنوب باعتبارها “أكثر تحضّراً” من المجتمعات السنية البدوية أو الريفية، اختزالًا لها في صورة “حاضنة التطرف” فهجر الفلاحون في الجزيرة السورية وقتلوا على يد قسد وهجر البدو وقتلوا على يد أنصار الزعيم الدرزي حكمت الهجري، هذه النظرة تعيد إنتاج منطق استعماري معروف لدى السوريين بالاستعمار التوسعي، حيث قدمت إسرائيل نفسها للعالم كأقلية متمدنة جاءت لتحتل فلسطين وسط “رعاع العرب”، نعم إنها بالضبط الفكرة التي استخدمتها سلطات الاحتلال لتبرير الاستيطان، وهي الفكرة ذاتها التي يردّدها بعض الزعماء الطائفيين في سوريا اليوم لخطب ود الامريكان والأوربيين ونتنياهو، كأنهم يرسمون خط تماس أخلاقي بين “مجتمع متحضّر” و”أغلبية همجية”.
فهذا الزعيم الدرزي حكمت الهجري، يكررها بخطابات التملق لواشنطن وتل أبيب، فيصف إسرائيل بالإنسانية وهي مستمرة بقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني ويصف الحكومة السورية بـ “الداعشية”، وهذا الكلمة بالضبط هي كلمة سر تبرير قتل العربي السني إنها رخصة قتل استخدمها القادة الكرد بحمالاتهم العسكرية تحت ظلال الطائرات الأمريكية، فأراد الهجري تقليدهم رغم أن عدوه ليس بـداعش، وهو الذي ظل حتى وقت قريب يرى في بشار الأسد “قائدًا حكيمًا” رغم مقتل مئات آلاف السوريين بطائراته وبراميله هذا عدا عن تدمير المساجد ودور العبادة.
معركة السويداء الأخيرة، كشفت تحوّلاً في خطابه، بدأ يصف خصومه بالهمج الذين لا يمكن العيش معهم، بل وصل إلى حد طلب العون من إسرائيل، وهو يعلم أن مجرد استدعاء اسم إسرائيل يفتح جرحًا إضافيًا لدى السوريين، فهي تحتل الجولان وشرّدت بدوه، كما فعل مسلحوه مؤخرا ببدو السويداء فجروا على المحافظة الحرب البعيدة فقتل المئات.
أخطر ما في الأمر حاليا، اصطفاف نخب بعض الطوائف خلف زعمائها المتعصبين وقيادة مجتمعاتهم لاتخاذ الموقف ذاته، وميل بعضهم للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال(صالح مسلم والهجري)، يجري تحت شعار “حماية الخصوصية” لكنه يخفي حمايةً فعلية لفلول النظام وضباطه وقادة ميليشياته المتهمين بجرائم حرب، هذا المسار سيجعل هذه المجتمعات ككل، شريكة في وزر الدماء التي سفكت خلال سنوات الثورة، إذا لم تُسلّم مجرميها للمحاسبة يعني أن القانون لن يسري عليهم وبالتالي سيصار لاعتماد قانون الغاب الذي سيجلب الويلات على البلاد.
المثل الأبرز جاء من الساحل، خرجت مظاهرات طالبت بإطلاق سراح ضباط الجيش المنحل من السجون، بينما لم تكن عمليات البحث عن جثث ضحاياهم في المقابر الجماعية قد اكتملت بعد فتطور الأمر لانتفاضة مسلحة، واليوم، تطل وجوه سياسية كردية مثل فوزة اليوسف لتتحدث عن المجازر في الساحل والسويداء وتقول: “لم نسلم رقابنا لهم”، لأنها تدرك أن ذاكرة القبائل العربية ما زالت محمّلة بمشاهد القتل بالقذائف والقصف والقنص للسكان العرب في الرقة ودير الزور حلب والحسكة باسم محاربة داعش إلى جانب قوات الاحتلال الأمريكي، ثم استغلت فقرهم بالتجنيد القسري للفتيان والفتيات والأطفال ليكونوا ضحايا مرتين.
إذن، حماية فلول النظام عبر التذرّع بالخصوصية الطائفية أو العرقية لن يحمي هذه المكونات، بل سيضعها في مواجهة وزرٍ أخطر من الخيانة والعمالة لإسرائيل أمام ضحايا وحشية نظام الأسد، إنه وزر الدماء التي سفكها ضباط النظام السابق مثل عصام زهر الدين وسهيل حسن ورجالهم في دير الزور وحمص وحماة وحلب وإدلب.
«لا يمكن لأي مشروع وطني أن يعيش دون عدالة انتقالية تحاسب المجرمين، وحدها محاسبة الأفراد لا الطوائف تقطع خيط الدم وتمنع امتداده إلى الأجيال القادمة»
نهاية القول، صوت الأقليات الذي ارتفع اليوم ليس دليلاً على وعي جديد، بقدر ما هو انعكاس لمخاوف متأخرة عندما أدركوا أنهم وقفوا بالجهة الخطأ لحظة فرار بشار الأسد، حتى احتاروا هل يرفعوا راية الثورة أم راياتهم الخاصة مشفوعة براية قوة احتلال كبرى أو صغرى!