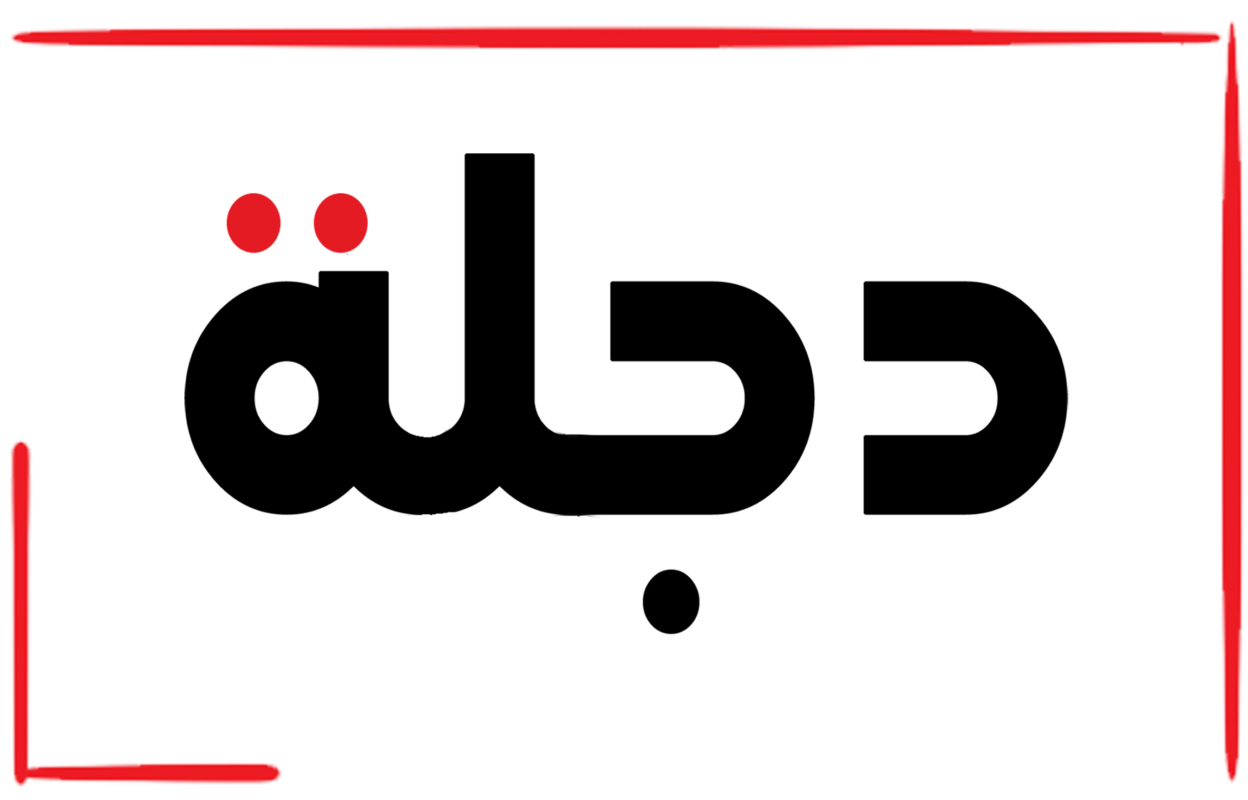مروان قبلان – العربي الجديد
بعد عشر سنوات على اندلاع الثورة السورية، وتحولها إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، بسبب سوء إدارة النظام وتمرّسه في العنف، وسوء تقدير المعارضة وأخطائها وقلة خبرتها، وفشل المجتمع الدولي في منع انزلاق السوريين إلى كارثة، واستغلال دول عربية وإقليمية الأزمة لتحقيق مكاسب أو تصفية حسابات مع خصومها، لا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن “الساغا” (الملحمة) السورية اقتربت من نهايتها. على العكس، تذهب كل الدلائل إلى أن الوضع السوري سوف يستمر في التحلل والتعفن، وصولاً إلى النقطة التي قد نشهد معها انهيار الدولة السورية، بعد أن تصدّعت أركانها بشدة خلال السنوات الماضية.
في مناطق النظام، يسيطر الجوع والفقر والمرض، ويتفسخ الوضع الاجتماعي والقيمي، وتتحكّم مليشيات بالوضع على الأرض، وتتصرّف خارج أي إطار قانوني خلاف ما تسمح به تبعيتها للراعي الإيراني أو الروسي. وفي مناطق المعارضة، يسيطر الدمار وتنتشر مخيمات اللجوء التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، وتتحكّم فصائل مسلحة على الأرض، لا يبدو أنها هي الأخرى تملك قرارها.
وفي كلا المعسكرين، يعيش ملايين الأطفال خارج إطار التعليم، أو يتلقون القليل منه، وتزداد بينهم مشاعر الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام، وسط غياب أي مظهر من مظاهر التعاطف مع معاناة “الآخر”، ما ينذر بظهور جيل جديد من “دواعش” الطرفين. مع ذلك، يستمر النظام في التظاهر بأن الوضع عاد إلى “حالة الطبيعة”، بعد أن انتصر على “المؤامرة الكونية” التي استهدفت إزاحته، وهو يعدّ العدّة لإجراء انتخابات رئاسية، يعد فيها مؤيديه بالنصر ويطالبهم بالصبر. في المقابل، تستمر المعارضة في التظاهر بأنها لم تُهزم، وأن قرارها ما زال بيدها، وتبث، فوق ذلك، الوهم أن إسقاط النظام ما زال ممكناً عن طريق المفاوضات واللجنة الدستورية، وأن الانتقال السياسي صار في الأفق وهي تستعد له.
في الأثناء، يستمرّ العالم المشغول بمشاغله الصحية والاقتصادية، التي فرضها تفشّي وباء كورونا، بالتظاهر أنه مهتم بحل الأزمة السورية. وفيما يصرّ شركاء أستانة على أن مسارهم قد يفضي إلى شيء، تصرّ واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون، على ترداد مطالبتهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي أصبح يعني للسوريين ما يعنيه القرار 242 للفلسطينيين، ويراهنون على أن العقوبات ستدفع النظام في نهاية المطاف (الذي لا يبدو واضحا أين ومتى وكيف سينتهي) إلى الرضوخ لشروط الحل السياسي. والنتيجة، بحسب الأمم المتحدة، أن 80% من السوريين المقيمين في سورية (في مناطق النظام والمعارضة) يعيشون تحت خط الفقر، و60% منهم (12,4 مليوناً) يعانون من الجوع، علماً أن العدد، بحسب برنامج الغذاء العالمي، ازداد بمقدار 4,5 ملايين شخص خلال عام واحد. وكأن هذا كله لا يكفي لجعل الوضع سيئاً، إذ فيما يستمر معسكرا النظام والمعارضة في الانتحار والتفسّخ، توضع سورية من جديد على طاولة المفاوضات الأميركية – الإيرانية، ولا يغيب عنها بقية الخمسة الحاضرين بجيوشهم على أرضها (روسيا وتركيا وإسرائيل)، وكل منهم يسعى إلى تأمين حصته فيها.
لا يمكن لأحد أن يرسم صورة واقعية أكثر قتامةً حول مستقبل بلدٍ تميز تاريخياً بأنه صانع حضارة، وانتهى به الأمر هكذا. كل هذا الكلام ينشد الوصول إلى الخلاصة التالية: بات الوضع يتطلّب من كل السوريين المؤمنين باستعادة وطنهم، على اختلاف مواقفهم السياسية ومذاهبهم الفكرية، الارتقاء الى مستوى الكارثة التي حلت بوطنهم، والتخلص من وهم أن معسكراً منهم قادر على فرض إرادته على المعسكر الآخر، والالتفات، بدلاً من ذلك، إلى تسخير كل الإمكانات للإجابة عن السؤال المصيري الذي يصفع الوجوه في هذه المرحلة: ما العمل؟ كيف السبيل إلى الخروج من هذه الكارثة، والانعتاق من لعبة الأمم وحرب المحاور الدائرة على أراضينا وبدمائنا؟ على المعارضة أن تعترف بوجود عقلاء في معسكر النظام يدركون حجم الكارثة ويريدون حلاً. وهناك في المقابل عقلاء في صفوف المعارضة يدركون الأمر عينه ويريدون حلاً. يجب إيجاد طرق للتواصل بين الطرفين، للتوصل إلى صيغة مشتركة للإنقاذ. وإذا لم يجد السوريون هذه الصيغة، فإن أحداً آخر لن يفعل. فالحل، بعد عشر سنوات من الكارثة، لن يأتي من موسكو أو من واشنطن، فنحن بالنسبة للأولى ساحة اختبار لسلاحها، وللثانية ورقة تفاوض وساحة لمقارعة التطرّف بعيداً عن أراضيها. الحل يأتي فقط من رحم المعاناة، وينشده أصحابها، ويصنعه العقلاء بينهم، بشرط أن يكونوا طبعاً سادة قرارهم.