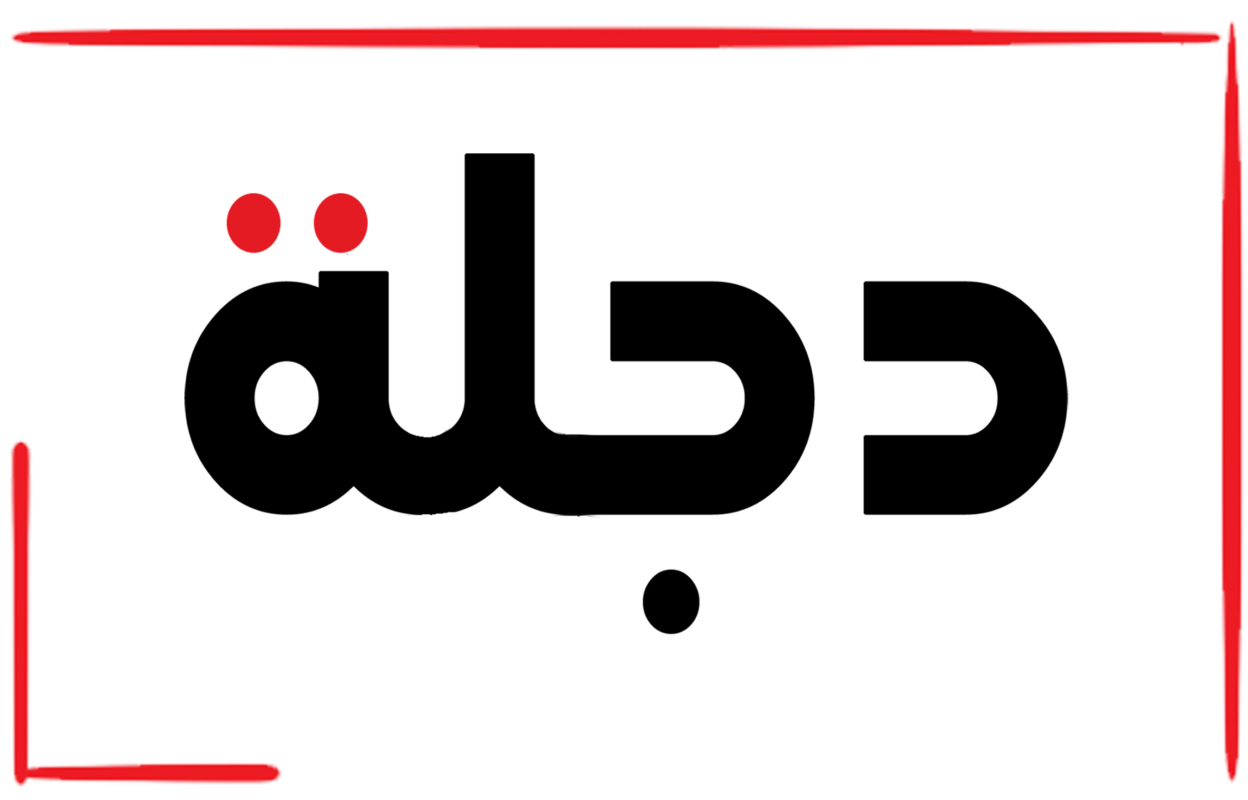يبدو أن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية الانتقالية، لم يكن مجرد مجاملة دبلوماسية، بل يعكس تحولًا جوهريًا في موقف باريس تجاه الملف السوري بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
يأتي هذا الاتصال في إطار التحضير لمؤتمر باريس المزمع عقده في 13 فبراير، والذي سيركز على ثلاثة محاور رئيسية: السيادة والأمن، الحوكمة والاستقرار، والمصالحة والعدالة الانتقالية. وأكد بيان الإليزيه أن فرنسا مستعدة لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، مشددة على ضرورة إشراك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هذه العملية، بالإضافة إلى اهتمامها بقضايا مثل الأسلحة الكيميائية والأمن ومكافحة الإرهاب.
إذا كان التاريخ يعلّمنا شيئًا، فهو أن التدخلات الخارجية غالبًا ما تترك تداعيات معقدة. واليوم، بينما تتحدث باريس عن دعم “السلطات السورية الانتقالية”، تبدو الصورة أشبه بإعادة إحياء لمرحلة الانتداب الفرنسي في القرن الماضي، حين استخدمت فرنسا الانقسامات العرقية والطائفية لتقسيم سوريا وإضعاف دمشق.
الحديث عن إشراك قسد في العملية الانتقالية يعيد إلى الأذهان أحداث عامي 1937-1938، عندما دعمت فرنسا ميليشيات كردية بقيادة حاجو آغا، وسريانية بقيادة إلياس مرشو، في تمرد ضد الدولة السورية الناشئة آنذاك، بهدف فرض واقع انفصالي في الجزيرة السورية قبل انسحابها. واليوم، يبدو أن باريس تدفع باتجاه احتواء قسد ضمن السلطة الجديدة، مما يثير التساؤلات حول مدى تشابه هذا النهج مع سياساتها الاستعمارية السابقة.
الهدف الرئيسي للحكومة السورية الانتقالية هو ضبط الأمن والاقتصاد في البلاد لتقليص فرص التدخلات الخارجية. فإذا تمكنت دمشق من استعادة الجزيرة سلمًا أو عبر تفاهمات سياسية، فلن يكون لأنقرة أي مبرر للاحتفاظ بـ”شريطها الأمني”، مما قد يدفعها إلى الانسحاب تدريجيًا أو بموجب اتفاق. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يتطلب ترتيبات واضحة لمنع أي قوى خارجية أخرى من استغلال الانسحاب التركي لصالحها، خاصة أن أنقرة لطالما اشترطت القضاء على الوجود المسلح لقسد قبل أي انسحاب، كما أثبتت عمليتها العسكرية “نبع السلام” رغم اعتراضات الدول الغربية.
وفي الجنوب، لطالما استخدمت إسرائيل الوجود الإيراني كذريعة لتكثيف ضرباتها داخل العمق السوري، إلا أن سقوط نظام الأسد وانسحاب الميليشيات الإيرانية يدفع تل أبيب للبحث عن مبررات جديدة. من جهة أخرى، تستمر القوات الأردنية في استهداف مواقع على الحدود السورية ضمن حملتها ضد عصابات تهريب المخدرات، التي باتت الأجهزة الأمنية السورية تلاحقها بشكل مكثف.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتبقى مسألة رفع العقوبات أولوية قصوى للحكومة في دمشق. لكن، هل يمكن الاعتماد على وعود فرنسا بقيادة حملة لإقناع الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات، أم أن هذه المسألة ستظل ورقة ضغط بيد القوى الكبرى؟ من الواضح أن بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، باتت أكثر انفتاحًا تجاه هذا الملف، ربما تحت ضغط أزمة اللاجئين التي تلقي بثقلها على السياسات الداخلية الأوروبية.
في هذا السياق، أكد ماكرون أن ملف العقوبات يُناقش بجدية، وأن فرنسا تلعب دورًا محوريًا في هذا الاتجاه. أما بشأن زيارة الرئيس الشرع إلى باريس، فلا تزال المسألة غير محسومة، لكن من المؤكد أن وزير خارجيته سيصل إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر، ليكون بذلك أول مسؤول سوري يزور دولة أوروبية عضوًا في مجلس الأمن منذ سقوط الأسد.
وكان وزير الخارجية السوري الانتقالي، أسعد الشيباني، قد ظهر في منتدى دافوس قبل أسابيع، في خطوة عكست دعمًا عربيًا، خاصة من السعودية وقطر، للتحرك الدبلوماسي الجديد لدمشق.
يمكن القول إن فرنسا تسعى إلى لعب دور مؤثر في سوريا الجديدة، لكن نجاحها في ذلك يعتمد على مدى قدرتها على تحقيق توازن بين دعمها لقسد، وعدم استفزاز أنقرة التي تصنفها منظمة إرهابية، وبين تعاطيها مع حكومة دمشق التي تواجه تحديات إعادة الإعمار وضبط الأمن.
كما أن قضية المقاتلين الأجانب المحتجزين لدى قسد تبقى مسألة حساسة قد تعقد أي تفاهمات مستقبلية، وتجدها باريس ركيزة أساسية للاحتفاظ بقسد ودعم مظلوم عبدي، بينما تتعامل بحذر مع تحرير الشام واحمد الشرع، الذي قطع علاقته بالقاعدة، بالمقابل من غير الواضح بعد ما إذا كان مظلوم عبدي سيتخذ خطوة مماثلة للتخلي عن حزب العمال الكردستاني، خاصة في ظل القرار الأممي 2254 الداعي إلى وقف القتال، إلى جانب أن جزءا من الشعب السوري المنخرط بالثورة يصنف قسد إلى جانب نظام الأسد منذ البداية.
أخيرًا، لا شك أن اتصال ماكرون بالشرع يشكل نقطة تحول في التعاطي الدولي مع سوريا بعد الأسد، لكن نجاح الحكومة الانتقالية سيظل مرهونًا بقدرتها على تحقيق توازن داخلي وخارجي يراعي تعقيدات المصالح الدولية والإقليمية، فضلًا عن المطالب الشعبية المؤجلة.