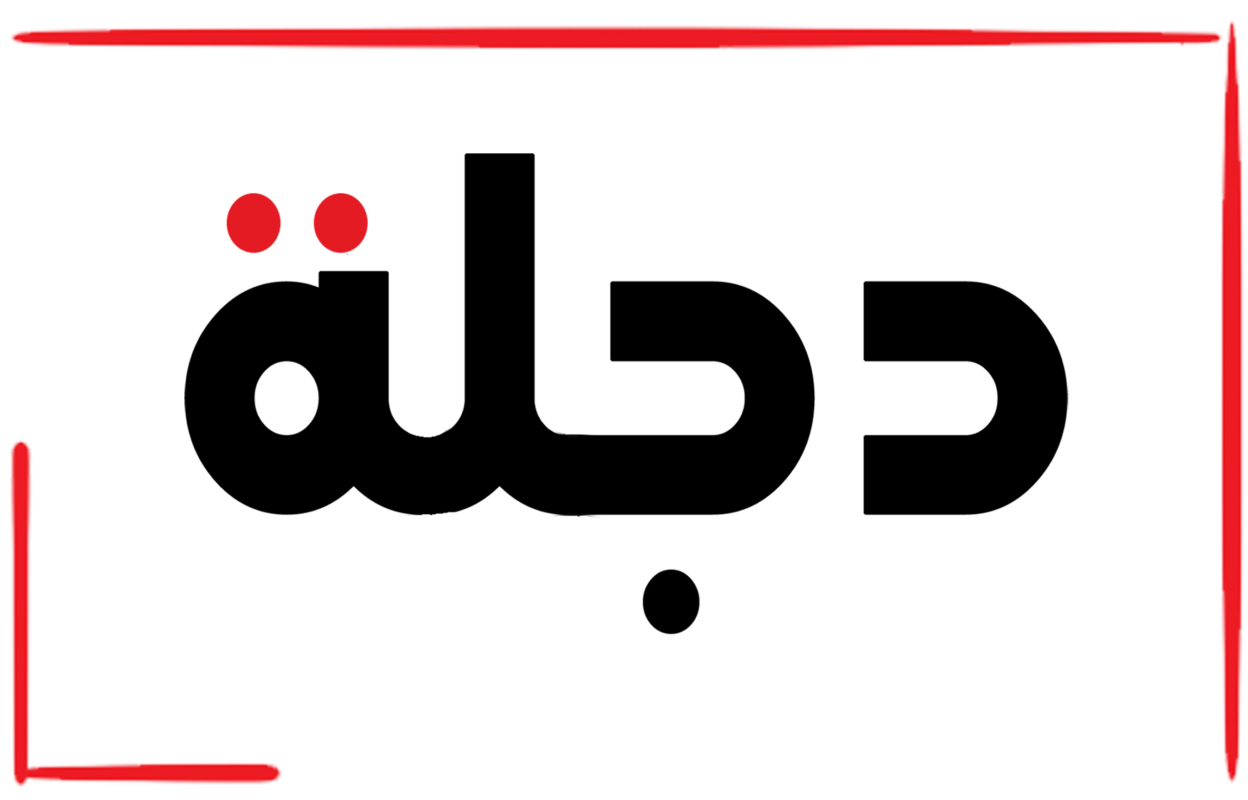شهدت الساحة السورية، منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، تطورات درامية في المشهد السياسي والعسكري، حيث برزت صراعات في الجزيرة السورية والشمال، في حين تحاول الحكومة المؤقتة لملمة أمور البلاد الداخلية في المناطق الخاضعة لها، وسط حراك سياسي مكثف لوفود أجنبية وعربية تصل تباعًا إلى دمشق، مع إصرار المجتمع الدولي، وخاصة مجموعة الاتصال العربية، على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وقد أثار ذلك أسئلة عديدة حول إمكانية تحقيق الاستقرار، وكيفية صياغة هيئة حكم انتقالي ودستور جديد، خاصة في ظل تعقيدات الملف الكردي.
قرار مجلس الأمن 2254، ينص على خارطة طريق لتسوية النزاع السوري تشمل وقف إطلاق النار، تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية، صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة بإشراف أممي. لكن السوريين يرون أن مهمة هذا القرار انتهت بمجرد سقوط النظام السوري عسكريًا ودون تدخل خارجي. إضافةً إلى ذلك، فإن هذا القرار يواجه تحديات عملية عديدة داخلية تتمثل بوجود قوى تسيطر على أجزاء من البلاد، تشترط على الحكومة الجديدة في دمشق التعهد بإشراكها في الحكم، وتعديل اسم الدولة، وعدم المساس بسلاح قواتها العسكرية.
ولم يتفقوا حاليًا سوى على رفع علم الاستقلال الذي تبنته دمشق وتقديم الدعم الكلامي للحكومة المؤقتة. لكنهم يؤكدون التمسك بالقرار الدولي لضمان إشراكهم على ما يبدو خشية تفرد “تحرير الشام” بالحكم، رغم أنهم (قسد والجيش الوطني) لم ينفذوا بنودًا مهمة يطالب بها القرار مثل إطلاق سراح المعتقلين، والسماح بمرور المساعدات لكل السوريين، وقبل كل ذلك وقف القتال، وهو أول البنود. فهناك منطقة محاصرة تشمل رأس العين وتل أبيض، ويشهد محيطها قتلاً مستمرًا، وكلا الطرفين مدعوم من دولة كبيرة.
لا يمكن تجاهل التعقيد الذي تضيفه القضية الكردية إلى المشهد، مع استمرار الخلافات بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والمجلس الوطني الكردي، ورفض الأولى إدخال البيشمركة السورية أو التخلي عن كوادر حزب العمال الكردستاني الذين يقودون الإدارة الذاتية. لذا، تبدو فكرة تشكيل وفد كردي موحد إلى دمشق بوساطة فرنسية-أمريكية بعيدة المنال، وعلى الأغلب سيذهب الكرد إلى دمشق بوفدين.
الإدارة الذاتية تطمح إلى طرح مشروعها في المؤتمر الوطني العام ليكون نموذجًا لكل سوريا، دون الاكتراث لسنوات طويلة من الحرب والفوضى، ودون إدراك أن الملف السوري يقف على أعتاب مرحلة جديدة قد ترسم ملامح مستقبل البلاد. وربما لأنهم يدركون حجم الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة على دمشق، ويريدون استغلالها للحصول على مكاسب حزبية عبر المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 كإطار جامع يقود العملية السياسية.
لكن ما مدى واقعية هذا الطرح في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها الساحة السورية؟!
منذ تبني القرار 2254 في عام 2015، لم يتحقق أي تقدم ملموس في تشكيل هيئة حكم انتقالي أو صياغة دستور جديد، فالنظام السوري، بدعم حلفائه، كان يتابع أعماله العسكرية لاستعادة السيطرة على معظم الأراضي السورية، بينما فشلت المعارضة في توحيد صفوفها أو تقديم رؤية شاملة للمستقبل استعدادًا للحظة سقوط النظام أو تحييده كعامل رئيسي في المعادلة السياسية. ففي حين كان الائتلاف وحكومته والجيش الوطني يمثلون نقيضًا له، كانت الإدارة الكردية وقسد تحاورانه دائمًا دون جدوى.
بالعودة إلى تجارب دول أخرى خرجت من نزاعات داخلية طويلة، نجد أن الانتقال السياسي الناجح يعتمد على توافق داخلي واسع النطاق، وليس على حلول مفروضة من الخارج. كالتجربة العراقية والليبية واليمينة، على سبيل المثال، أظهرت أن إقصاء أطراف رئيسية أو الاعتماد المفرط على الدعم الدولي يؤدي إلى نتائج كارثية.
وبخروج النظام من المسرح مع دخول أطراف جديدة إلى المشهد السياسي، يطالب بعض السياسيين بالتريث وعدم الاستعجال إلى حين بناء القوى السياسية والتيارات برامجها السياسية وإقناع قواعدها الشعبية، حتى لا تستولي القوى الجاهزة من التنظيمات القديمة على السلطة دون منافسة حقيقية. فيما ينادي البعض بالعودة إلى دستور 1950 واعتماده للفترة الانتقالية إلى حين إعداد دستور جديد، نظرًا لكونه سابقًا لفترة حكم حزب البعث. خلال هذه الفترة، تُجرى انتخابات جمعية تأسيسية تُناط بها مهمة صياغة دستور جديد يحدد النظام السياسي المقبل.
في الوقت نفسه، يجب دعم الحكومة المؤقتة في دمشق لتعمل على استعادة الأمن والخدمات الأساسية، بإعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية، وضمان دمج الفصائل المسلحة تحت قيادة موحدة، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية يعالج الانتهاكات التي شهدتها البلاد، من خلال إنشاء لجنة عدالة انتقالية للتحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين.
وهنا بالذات، باتت قسد عائقًا رئيسيًا ليس فقط أمام تحقيق الاستقرار في الجزيرة، نظرًا لموقفها المتشدد وارتباطها بحزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا، وإنما لجهة استعادة السيطرة من قبل دمشق على الموارد الحيوية والثروات الطبيعية ومؤسسات الدولة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.
كل هذا، قبل تشكيل محاكم خاصة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى، وإطلاق برامج مصالحة وطنية مدعومة دوليًا، وإشراك أوسع طيف من القوى السياسية في العملية السياسية لإبعاد شبح التدخلات الخارجية.
هذه التدخلات كانت بدايتها من اجتماع “العقبة”، حين حاولت الدول الغربية والأمم المتحدة مع الدول العربية استعادة زمام المبادرة بعد فقدانها خيوط اللعبة السياسية نتيجة الانهيار السريع وغير المتوقع لنظام بشار الأسد، الذي كان مقتنعًا أن مسار أستانا هو المخرج الآمن من أزمته في مواجهة الثورة السورية. لكن كما يقال: “يؤتى الحذر من مأمنه”، فدفع الأسد ثمن تعنته، فجعلت تركيا وروسيا أستانا يكتب الفصل الأخير في قصة نظام ديكتاتوري حكم البلاد لأكثر من خمسة عقود، من خلال الاتفاق على تركه وحيدًا في مواجهة الفصائل العسكرية السورية.