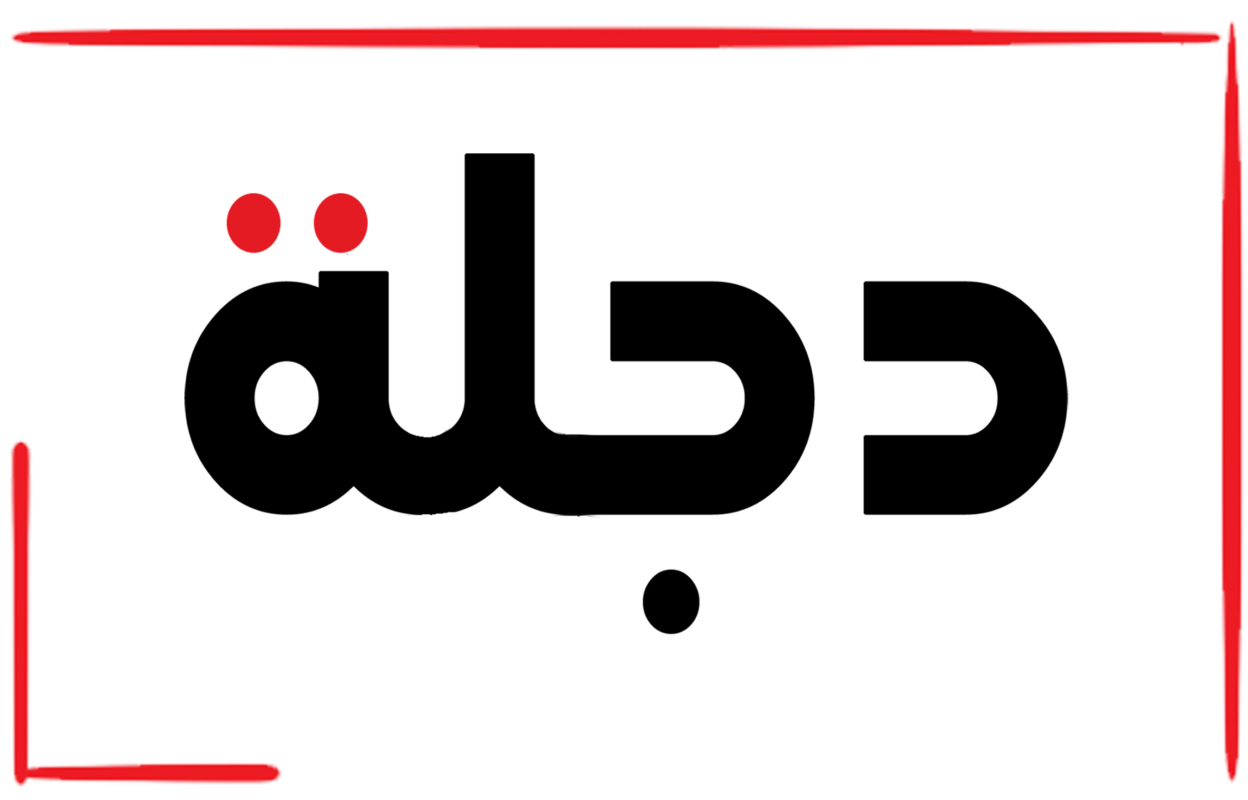استفاق العالم يوم الثامن من كانون الأول 2024 على خبر سقوط أحد أشرس الأنظمة الحاكمة وأكثرها دموية في التاريخ المعاصر. فُتحت أبواب دمشق بيد ثوارها وتحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
رغم احتفال ملايين السوريين في ساحات دمشق وحلب وحمص وحماة وسائر المدن وفي دول اللجوء تحت تأثير نشوة الانتصار والتحرر من نظام ظن نفسه خالدًا إلى الأبد، فإن الآراء حول اليوم التالي لسقوط بشار الأسد انقسمت، واستولت الهواجس والمخاوف على شريحة واسعة رغم رسائل قوى الثورة والأفعال المطمئنة التي أظهرتها الفصائل العسكرية، وبقي كثيرون متوجسين من قدرتها على استلام مقاليد الحكم وإدارتها.
هذا الانقسام في الشارع السوري تمحور حول فكرتين فكرتين رئيسيتين: الأولى- بإعطاء القيادة الجديدة وقتًا لتلمس الطريق، ووجوب الالتفاف حولها ودعمها. يرى هذا الفريق أن القيادة الجديدة ربما تكون الأحق بالحكم، رغم الاختلاف الأيديولوجي والعقائدي معها.
حجج هذا الفريق متعددة. أولاً، الحكام الجدد تسلموا بلدًا مدمّرًا على شفير الهاوية، وكرسي الحكم يبدو مهلهلًا. ثانيًا، التروي يمكن أن يساعد في إبقاء شعلة النشوة العاطفية والأمل متقدة في شعب عانى الويلات. ثالثًا، الخوف من الانفلات التام، الذي قد يؤدي إلى ثورة مضادة أو حتى حرب أهلية جديدة، يجعل التريث ضرورة. وأخيرًا، لأن كل البوادر المرسلة حتى الآن تُظهر خطابًا سياسيًا موزونًا ومتوازنًا وسلوكيات ذات حس وطني جامع.
أما الجانب الآخر من الشارع، يتبنى الفكرة الثاني: الانتقاد والتخوف من أن ما سبق ليس إلا مناورة سياسية تهدف إلى حشد الشعب السوري المتنوع وكسب ثقته من جهة، ومغازلة الدول الوازنة، وخاصة الغربية، من جهة أخرى، ليتمكن القادة الجدد من الانقضاض على الحكم لاحقًا. أي أن الخطاب السياسي الجديد ليس سوى لعبة تبديل ملابس مؤقتة، مصيرها الانتهاء بمجرد انتهاء فاعليتها. وبذلك، فإن الالتفاف الأعمى حول الحكومة الجديدة ما هو إلا تعبيد للطريق نحو حكم أحادي، وما النموذج الإيراني إلا مثال صارخ يطرحه أصحاب هذا الرأي؛ فأسلمة الدولة، في رأيهم، لا تأتي إلا تدريجيًا وبهوادة.
يبدو أن هيئة تحرير الشام، الفاعل الأقوى في سلطة الأمر الواقع الحالية، قد بدأت فعليًا بمواجهة تحديات معقدة منذ اليوم الأول للتحرير. تشمل هذه التحديات إدراجها على قوائم الإرهاب الدولية وإدراج قائدها أحمد الشرع (الجولاني)، الأمر الذي يقيّد تحركاتها السياسية ويزيد من عزلتها خاصة أن سوريا منذ عهد حافظ الأسد (1979) مصنفة كأحد البلاد الراعية للإرهاب. إضافة إلى ذلك، تواجه الهيئة ضرورة التوفيق بين تاريخها العسكري والإداري السابق وبين تطلعات السوريين بالحرية والكرامة ولدولة مدنية حديثة. مثال على ذلك هو إدارتها للمناطق التي سيطرت عليها في إدلب، والتي شهدت انتقادات واسعة بسبب تقييد الحريات وتطبيق سياسات مثيرة للجدل.
فضلاً عن ذلك، يشكل تقديم نموذج حكم شامل يراعي التنوع السوري ويطمئن الأطراف الدولية تحديًا بالغ التعقيد. تبدأ هذه المعوقات بتواجدها على قوائم الإرهاب، وثقل تاريخها العسكري والإداري في أماكن سيطرتها السابقة، ولا تنتهي بضرورة إعادة هيكلتها وتصدير صورة أكثر حداثة واعتدالًا، بما يتناسب مع متطلبات النسيج السوري وثورته وتطلعات شعبه.
وقد برزت هذه التحديات إلى السطح عندما تعاملت مع الواقع السوري باعتبارها صاحبة اليد العليا ومصدر القرار. إذ ما لبثت أن عينت حكومة تصريف أعمال انتقالية منبثقة عن حكومة الإنقاذ في إدلب، ومن المقربين إلى التنظيم، باعتبار التجربة الإدلبية نموذجًا قابلاً للاحتذاء والبناء عليه. مع العلم أن هذه التجربة كانت قد عانت ما عانت من اضطرابات وتصرفات أثارت، وما تزال تثير، تخوف شريحة من السوريين، الذين ازدادت ريبتهم نتيجة غياب خطة عمل واضحة لهذه الحكومة الانتقالية، بالتزامن مع إصدارها، بالتوازي مع قائد هيئة تحرير الشام، قرارات ذات طابع هيكلي وسيادي تتجاوز مجرد تسيير الأعمال.
وفي هذا السياق، على هيئة تحرير الشام أن تدرك أنها أمام لحظة تاريخية تحمل في طياتها تأثيرات تتجاوز حدود سوريا. هذه اللحظة قد تسهم في إعادة تعريف صورتها على الساحة الدولية، سواء من خلال تقديم نموذج حكم جديد أو عبر إحداث تغيير في التوجهات السياسية العالمية تجاه التيارات الإسلامية. ففي يديها الآن فرصة لتحرير المسلمين من وصمة الاستبداد والإرهاب التي طالما عانوا منها، وتقديم نموذج حديث طالما حلموا به وادعوا إمكانيته إذا توفرت الظروف. لذا، فإن الهيئة قادرة الآن على التنصل من فكر الإسلام الجهادي الراديكالي ذي الحكم الشمولي، والخروج من سردية الضحية والاستهداف الإسلاموفوبا، وتقديم سردية تتماشى مع مفاهيم الدولة الحديثة، التي تضمن التعددية الفكرية والعقائدية والحريات بجميع مستوياتها، وعلى رأسها حرية المرأة، وهي الثغرة التي تستغلها قوى أخرى لكسب التأييد الغربية مثل “الإدارة الكردية”.
الظاهر أن قيادة الهيئة ممثلةً بقائدها بدأت باستيعاب حجم المهمة وضرورة تصدير صورة جديدة تخرجهم من عقلية الحشد العاطفي والعقائدي إلى عقلية إدارية ذات أبعاد أكثر شمولًا وانفتاحًا، حاضنة لتكوينات سوريا المعقدة والمتشابكة وواعية لتحديات البلد الجيوسياسية.
في خضم كل هذه التشابكات، على الشعب السوري ألا يفقد البوصلة عبر الاصطفاف خلف الشعبوية والعاطفية السياسية، بل عليه الاتسام بالموضوعية والتحليل البراغماتي لمجريات الأمور، فهما حجر الأساس الأول لسوريا بعيدة عن التهييج والمزاجية والتبعية.
أخيرًا، وجب التذكير أن سوريا قبل سقوط الأسد لم تكن سوى سوريا الرهينة، حيث كان وضعها مثقلًا بالتدخلات الخارجية، إقليمية كانت أو عالمية، والحرب الأهلية التي يعتقد البعض أنها تلوح في الأفق كانت قد بدأت فعلاً في عهد الأسد الذي جيّش، حشد وحقن الدولة طائفيًا وعقائديًا ومناطقيًا على مدى عقود. أما الواقع المعيشي، فنستطيع بكل سهولة رسم منهجية النظام لسحقه قبل الثورة أو بعدها حين بدأت الحكومة التخلي عن القطاع العام لصالح القطاع الخاص لتقليل الإنفاق العام وهي ليست سوى عملية إعدام للقطاع العام.
السوريون ورثوا نتيجة لوحشية النظام المخلوع بلدًا مدمّرًا على حافة الانهيار، ولذلك، ورغم كمّ التخوفات المهولة والمشرعة التي يعيشها السوريون، فإن نافذة أمل قد فُتحت لحظة هروب الأسد.
السوريون ما زالوا على خطى الحرية، رغم الصعوبات الجسيمة التي تواجههم. فقد اتخذوا خطوات نحو بناء مجتمع مدني متماسك، مثل إطلاق مبادرات محلية لإعادة الإعمار وتعزيز المصالحة الوطنية، إلا أن التحديات ما تزال كثيرة، من بينها استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتجنب الانقسامات الداخلية.
الجدال والخلافات الحاصلة حاليًا ما هي إلا نتاج صحي ومفيد لبناء بلد مليء بالأمل، بلد حكامه هم خدام شعبه، لا تقدم عطايا أو صدقات بل حقوق للشعب، لا شرطة ضمير أو أخلاق على المقاس، ولا كمامة أو أقفال على الأفواه!