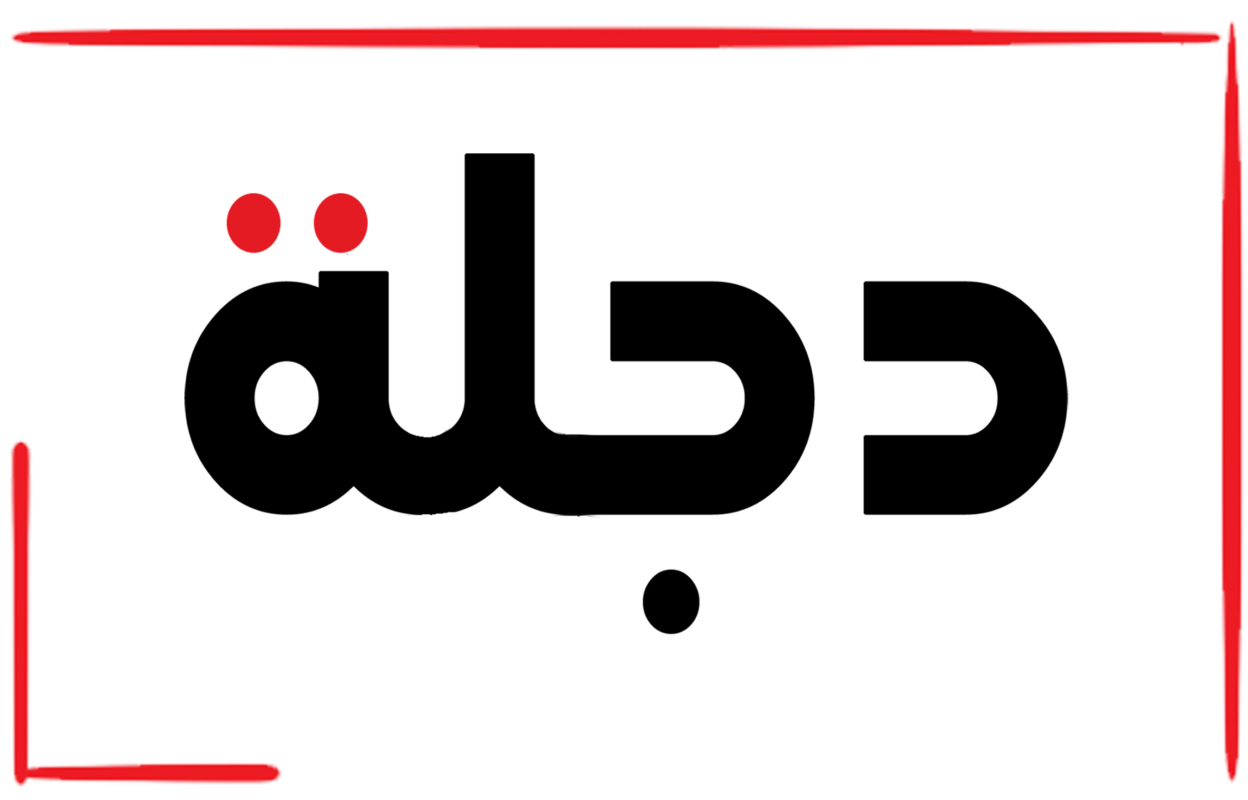خسرنا قبل أيام ابن عمي ،عامر أبو أكرم (1982-2026)، لأن النفط — في الجزيرة السورية — أصبح أخطر من الحرب نفسها، بل أحد أسباب اشتعالها المتكرر منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
في مساء بارد نحو الساعة 21:00 من يوم السبت 10 كانون الثاني، اشتعل صهريج لنقل المشتقات النفطية في قرية السليمانية قرب مدينة الحسكة بسبب ماس كهربائي، كان يقوده عامر برفقة ابنه علي، وبسرعة بديهته المعهودة، حاول إبعاد بيدون بنزين من الصندوق الجانبي قبل أن تلتهمه النيران، لإنقاذ ولده والشاحنة، لكن البنزين كان قد تشبع بالحرارة، فانفجر عندما ارتطم بالأرض، وعاد (البيدون) إليه كقذيفة، أصيب بحروق واسعة في ظهره، ومع ذلك — في لحظاته الأخيرة — فصل مقدمة المركبة عن الخزان، وطلب من ابنه الابتعاد بها.
نُقل إلى مشافي الحسكة ثم إلى دمشق، المدينة التي خذلته أكثر من مرة، بعدما طاف سابقًا بمشافيها بحثًا عن شفاء لولديه، قبل أن يفقد أكبرهم عام 2021، واستمر بدفع 1200 دولار شهريا ثمن علاج الآخر.
قصة عامر ليست استثناءً، بل نموذجًا مأساويًا لواقع يومي في منطقة تُدار فوق بحر من النفط، لكنها تعيش بلا وقود آمن، ولا منظومة إسعاف كافية، ولا مساءلة.
- من هنا تبدأ الحكاية، ومن هنا يجب أن يبدأ السؤال: كيف تحوّلت ثروة الجزيرة إلى آلة موت يومي؟
ففي جزيرة “دجلة والفرات”، لا يموت الناس بالمعارك أو برصاص الدوريات العسكرية والمداهمات وقطاع الطرق واللصوص فقط، بل بفعل النفط — الثروة التي كان يُفترض أن تكون رافعة للازدهار — وقد أصبح مصدرًا يوميًا للموت البطيء، وأحيانًا للموت السريع جدًا، نتيجة حرائق ناجمة عن المحروقات الرديئة في المخيمات والقرى والمدن، وحتى على الطرقات وفي الحراقات (براميل التصفية عبر حرق النفط).
كل يوم تقريبًا، يُنقل طفل أو امرأة أو رجل من مدن وقرى الجزيرة إلى دمشق للعلاج من حروق خطرة أو أمراض سرطانية، تظهر كنتائج مباشرة لاستخدام مشتقات نفطية رديئة جرى تكريرها بوسائل بدائية، بلا رقابة صحية أو بيئية، وبلا أي مساءلة رسمية.
المفارقة المؤلمة أن المنطقة التي تختزن أكبر حقول النفط السورية (العمر، الجبسة، تشرين، ورميلان) لا تملك مستشفى قادرًا على علاج حروق الدرجات العالية، والوقود المتاح للسكان نادر، ملوث، وخطير في جميع المراحل (التصفية، النقل، الاستخدام).
أمّا في بعض المناطق، مثل رأس العين وتل أبيض، يصل سعر البرميل إلى نحو 130 دولارًا، فإذا استُخدم للتدفئة قد يخنق الأطفال أو يهدد حياتهم نتيجة الانفجار، وإذا استُخدم في المركبات قد يعطّلها أو يحرقها، أما مخلفات التكرير البدائي فتلوث التربة، كما أن تسرب النفط من الأنابيب والحقول يجعل الأودية والجداول تسيل حاملة معها التلوث والأمراض إلى القرى الأشد فقرًا، ومخلّفة دمارًا طويل الأمد في التربة والمياه والهواء.
يعتمد جزء واسع من السكان على مشتقات نفطية مصفّاة بطرق بدائية، دون معالجة حقيقية أو معايير أمان، والنتيجة مئات الحوادث سنويًا من انفجارات مواقد ومدافئ ومولدات وسيارات، وعشرات المرضى الذين لا يجدون حتى فرصة علاج مناسبة داخل مناطقهم.
ورغم ذلك، تبقى سلطات الأمر الواقع، على امتداد الجغرافيا السورية، خارج دائرة المساءلة: لا إحصاءات رسمية، ولا تقارير صحية شفافة، ولا سياسات حماية. ويُختصر كل شيء بعبارات جاهزة مثل “قضاء وقدر”، وكأن الكارثة الطبيعية هي التي تدير المصافي البدائية وتوزع الوقود الملوث.
فرغم اعتماد الإدارة الذاتية الكردية بشكل شبه كامل على عائدات النفط، لا تزال حالة البنية التحتية سيئة، وفي هذا الصدد، صرّح رئيس هيئة المالية أحمد يوسف أن حجم الموازنة العامة لعام 2026 بلغ نحو 1.577 مليار دولار أميركي، وأن 75% من إيرادات الخزينة تعتمد على القطاع النفطي، بعد أن كانت النسبة تصل إلى 97% خلال عامي 2020–2021.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن لمنطقة تموّل ثلاثة أرباع ميزانيتها من النفط أن تعجز عن توفير وقود آمن، ومستشفيات قادرة على معالجة الحروق، ونظام رقابة بيئية يحمي السكان وأطفالهم من السموم؟
في المقابل، يحاول الرئيس السوري أحمد الشرع الإجابة بالقول: إن إيرادات النفط تُصرف على حفر الأنفاق أو تُرسل إلى خارج البلاد، مؤكدًا أنه — لو أُتيحت إدارة مركزية واستثمارات حديثة — يمكن إنتاج ما يصل إلى مليون برميل نفط يوميًا، بعائد سنوي يقارب 20 مليار دولار للدولة السورية. وأضاف أن المنطقة كانت تنتج سابقًا بين 400 و600 ألف برميل يوميًا. ووفق هذا المنطق، لا تمثل الأزمة خسارة مالية فقط، بل ضياع فرصة تاريخية لإعادة الإعمار وبناء اقتصاد مستقر، فيما لا تنعكس هذه الموارد اليوم تنميةً ولا خدمات ولا بنية صحية أو بيئية على السكان المحليين.
النفط في الجزيرة السورية لم يقتل عامر وحده، بل يقتل من ينقله، ومن يصفيه بالحراقات البدائية، ومن يستخدمه للتدفئة والزراعة والنقل، وفي الوقت الذي يتحول فيه النفط إلى مادة نزاع إقليمي ودولي بوصفه فرصة استثمار، يُترك سكان المنطقة وحدهم في مواجهة مخاطره الصحية والبيئية، بلا حماية ولا محاسبة.
استمرار الفوضى في إنتاج النفط وتداوله لا يقل خطرًا عن فوضى السلاح، لأنه يقتل بصمت وعلنا، ويدمر البيئة ببطء، ويُفلت القاتل دائمًا من العقاب، هكذا تطارد لعنة النفط “أهل الجزيرة” في الهواء والماء والتراب، بينما لا يتذكرهم أحد إلا حين يتحدث عن آبارهم والحقول، لا عن مصير أطفالهم بالمستقبل.