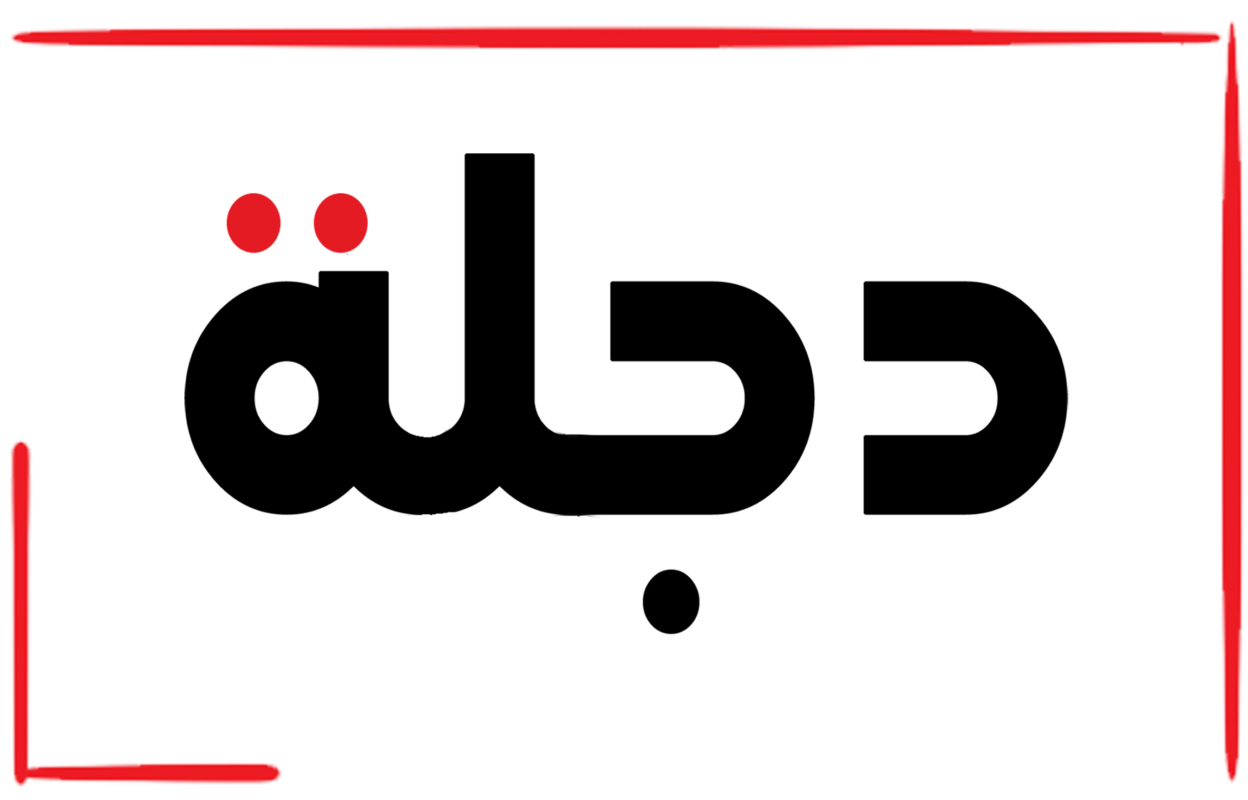لم يعد التحذير وحده مجديًا. الاحتجاجات التي خرجت عن السيطرة تضع الحكومة السورية الجديدة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة التوازن الدقيق بين صون حقّ التعبير ومنع الانزلاق إلى صدامات أهلية، كما يجري اليوم في مدينة اللاذقية، ضمن بيئة مثقلة بالإرث الأمني والاقتصادي والطائفي الذي خلّفه نظام الأسد، وتتأثر في الوقت نفسه بتدخلات إقليمية نشطة وظاهرة في الشمال والجنوب والشرق، وأكثر خفاءً في الساحل السوري.
أحد أخطر التصرفات التي ارتكبتها السلطات السورية تمثّل في السماح بنزول مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة في التوقيت والمكان نفسيهما، بما يعني عمليًا دفع الشارع إلى مواجهة الشارع، وخلق «ثأر اجتماعي جديد» بين المجتمعات، في وقت يراهن فيه السوريون والمجتمع الدولي على الحكومة، بكل ما لها من إرث ثقيل، لمنع هذا السيناريو لا لتكريسه.
وأيًا كانت نوايا المسؤولين ومبرراتهم، فإن إدارة الأزمات عبر مواجهة الشارع بالشارع تمثّل خطأً جسيمًا، فالدولة لا تُدار بمنطق «من يحشد أكثر»، ولمسنا ذلك خلال الأشهر الماضية، حين خرجت مظاهرات بدعوات من غزال غزال، وجرى الاحتفاء حينها برجال الأمن لصبرهم وحمايتهم لتجمعات المحتجين واعتصاماتهم، رغم الظروف الجوية القاسية، قبيل الذكرى الأولى لسقوط بشار الأسد، يومها شهدنا حشودًا مؤيدة ضخمة لا يمكن السيطرة عليها ولا حمايتها، وكان الأجدى، ترك المحتجين يعبّرون عن مطالبهم، ثم فتح قنوات نقاش واضحة، بدل تحويل الشارع إلى ساحة احتكاك كما يحدث حاليًا في اللاذقية، وهي لحظة تنتظرها كل القوى المطالبة بالفدرالية أو الانفصال.
في هذا السياق، يصبح الفصل بين المجتمعات المحلية وقياداتها السياسية أو العسكرية أمرًا بالغ الأهمية، يجب الفصل بين المجتمع الدرزي وحكمت الهجري الذي أعلن تعامله العلني مع إسرائيل ببيانات رسمية، كما يجب الفصل بين غزال غزال والمجتمع العلوي، حتى لا تُختزل المسألة بتحميل الطائفة جرائم نظام الأسد، وهي جرائم ما زال طيف واسع من السوريين يطالبون بالقصاص لضحاياها من الشهداء والجرحى والناجين والناجيات من معتقلات الموت، ممن يحملون ندوبًا عميقة في أجسادهم ونفوسهم، هذا ما ينبغي شرحه بوضوح للمطالبين بالإفراج عن ضباط النظام وجنوده، المتورطون بجرائم قتل أو تعذيب أو إخفاء قسري أو اغتصاب، وعدم محاسبتهم سيفجّر الوضع حتمًا ويفقد الضحايا وذويهم الثقة بعدالة الحكومة، التي أطلقت العشرات من الجنود السابقين قبل يومين في جبلة.
في المقابل، لا يمكن التعامل مع الساحل السوري بوصفه مجرد مساحة جغرافية أو خزان بشري للأجهزة العسكرية والأمنية. فهو كتلة اجتماعية منهكة دفعت أثمانًا باهظة خلال عقود من التهميش التنموي، ما دفع أبناءه للاعتماد على الوظائف العسكرية والأمنية على حساب الاقتصاد المنتج، والزراعة، والسياحة، والمرافئ، وحرمهم من القدرة على إدارة حياتهم خارج الراتب والسلطة.
العلويون في الساحل بحاجة إلى مقاربة حكومية جادة تبشّرهم بالتنمية والعيش الكريم، لا إلى خطاب أمني فقط ناهيك عن الخطاب الطائفي المنتشر، فإسرائيل تتربص بسوريا وتسعى إلى إضعافها لمنع تشكّل أي جيش وطني قادر على المواجهة، ولم يتردد نتنياهو بتكرار الحديث عن الحدود الأمنة وحماية الدروز والأقليات متدخلا بشؤون سوريا خلال مؤتمره مع ترامب، فيما تحاول إيران الحفاظ على خطوط نفوذها وطرق إمداد السلاح إلى حزب الله في لبنان، ولو عبر تأسيس كيان شبيه بحزب الله في الساحل السوري، بالاعتماد على شخصيات مثل غزال غزال وميليشيات مسلحة كـ«سرايا الجواد» و«أولي البأس»، بعد أن قُطع الطريق على مجلس غياث دلة العسكري، كما قُطع سابقًا على مجلس طارق الشوفي في السويداء.
الأخطر يتمثل في تلاقي التحركات الإسرائيلية والإيرانية في الجزيرة السورية، حيث تسيطر القوات الكردية (قسد)، المتعاونة مع الأمريكيين والروس في آن واحد، تحسبًا لأي تحرك تركي ضدها، وتشير تسريبات صوتية إلى أنها متورطة بالساحل وتدرب مسلحي الهجري بهدف كسب التأييد لمشاريع «اللامركزية» و«الفدرالية» و الاحتفاظ بــ «جيش مستقل»، ما يخدم مصالحها في المماطلة بالاندماج ضمن الجيش الوطني الجديد في الوقت الذي انتهى فيه العام الأول بعد سقوط الدكتاتور.
وكما استغلت قوى الثورة السورية نتائج الحرب الإيرانية–الإسرائيلية لإسقاط بشار الأسد، قد تحاول إيران اليوم استغلال أي احتكاك بين دمشق وتل أبيب لتحقيق مصالحها في الساحل السوري، وفق منطق «ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه»، مستندة إلى بقايا النظام للعودة إلى التحكم بجزء من سوريا على غرار كيان حزب الله بلبنان، وهو ما يلتقي مع مصالح كل المتضررين من سقوط الأسد.
تعزّز هذه المخاوف تقارير بالصحافة اللبنانية عن انتقال عائلات من الساحل إلى لبنان، وإنشاء حزب الله مخيمات لهم، إضافة إلى أنباء أوردتها سانا عن اعتقال حرس الحدود السوري مجموعات من ضباط وجنود النظام السابق خلال الأيام الماضية، فالإيرانيون وحلفاؤهم لا ينظرون إلى الساحل بوصفه مجتمعًا مظلومًا يحتاج إلى العدالة والتنمية والكرامة، بل كأداة ضغط أمني وسياسي على الدولة السورية الجديدة.
في سياق أحداث اللاذقية، تعرّضت الحكومة السورية لانتقادات حادة واتهامات بالتفريط، حتى تجرأ عليها بقايا نظام الأسد، أما الواقع يشير إلى خشيتها من استخدام القوة الأمنية في الساحل، تجنبًا لإعادة إنتاج دائرة عنف شبيهة بما جرى في آذار/مارس 2025، ثم السويداء في الصيف الماضي التي راح ضحيتها مئات الضحايا من كل طرف، ما يفرض عليها الإسراع في إنجاز ملف العدالة الانتقالية، وإشراك ذوي الضحايا والمعتقلين، وإعلان قوائم المطلوبين، أو على الأقل وضع معايير واضحة للمساءلة(ضباط أمراء، متطوعون…الخ)، بما يحقق العدالة ويؤسس لمساواة فعلية بين السوريين.
بعد عام على سقوط بشار الأسد، الأعباء هائلة والمتربصون كثر، وإطالة المرحلة الانتقالية دون رؤية سياسية واضحة وتنظيم حقيقي للحياة العامة لن تخدم الدولة، بل فرصة لخصومها وطلاب التقسيم، فسوريا لا تحتاج مظاهرات مضادة، بل حكومة تحصّن الداخل قبل التفاوض مع الخارج، حتى لا ننتظر طويلًا استقرار الساحل وعودة الجزيرة السورية.
ونهاية القول دائما الأسوأ لم يحدث بعد، فشل اغتنام اللحظة التاريخية الراهنة قد يدفع البلاد نحو مواجهات طائفية شاملة، ويفتح الباب أمام فدرلة أمر واقع لا تعبّر عن إرادة السوريين، واللاذقية مثال حي على الصدامات الأهلية الدامية.